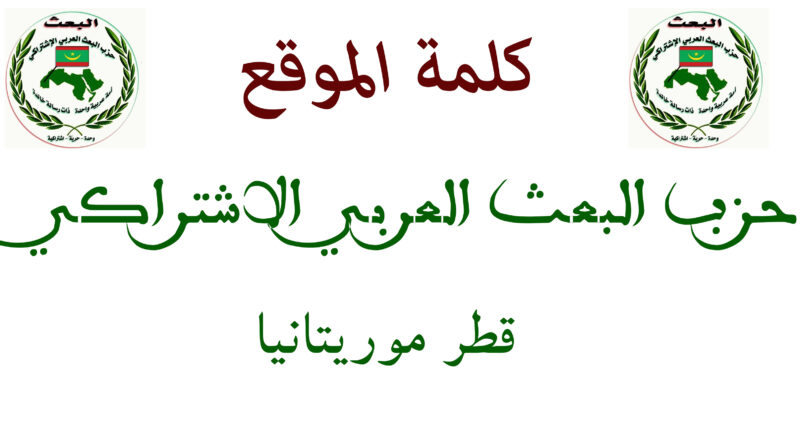بعد نتائج الانتخابات.. كيف الخروج من مأزق ابتلاع السلطة للمعارضة التقليدية؟
الانعطافات التاريخية هي تلك الأحداث الكبرى التي تترك تأثيرها محفورا في ذاكرة أكثر من جيل. و التاريخ بطبيعته متحرك بأحداثه و قيمه. و موريتانيا الحديثة مرت بأحداث تركت تأثيرا كبيرا على وعي انسان هذه الأرض. و من هذه الانعطافات :
1- الغزو الفرنسي لبلادنا و ما سعى إليه من تغيير للمنظومة القيمية و اللغوية، سبيلا لتبديل الدين لدى جزء من الشعب ، على الأقل.
2- الحصول على “الاستقلال” ١٩٦٠ و ما خلفه من ارتياح نفسي و معنوي على السكان ، لكن أيضا ما تسبب فيه من تصدع و انقسام ” للنخبة” يومئذ ما بين خيار الاستقلال أو الانضمام للمغرب؛ الأمر الذي ما زال يفرض تداعياته حتى اليوم على خيارات النخبة الوطنية المنقسمة ما بين من يؤيدون الاستقلال بكياننا و بين من يجدون أن خيار الانضمام للمغرب كان أكثر وعيا و أبعد استشرافا ؛ منطلقين من فشل البلاد بعد ستة عقود في إرساء مقومات الدولة العصرية التي تذيب فيها كل الكيانات التقليدية( القبائل، الشرائح، الأعراق). كذلك لم تتمكن من حسم هويتها التي جرى إهمالها عند التأسيس القسري للدولة، بسبب من ضعف وعي المؤسسين بخطورة عدم حسمها. فظلت هذه الهوية معوّمة و ظل البلد ، بموجب ذلك، ملغوما بكامل مرافقه و مؤسساته… و مهددا في استقراره.
3- 1973-1975: شكلت هذه السنوات منعطفا امتزجت فيها الفرحة بالصدمة و الابتئاس. ففي ١٩٧٣ كان إنشاء الأوقية و تأميم شركة المناجم الوطنية مناسبة ارتياح عظيم. لكن السنة ١٩٧٥ حملت شؤم الحرب على جزء من العرب البيظان الذين فصلهم الاستعماران الفرنسي و الإسباني عن عمقهم البيظاني في موريتانيا. فكان لاسترجاع هذا الجزء بالقوة أكبر الضرر على تماسك موريتانيا ، المجتمع و الدولة الفتية، لولا تنحية النظام السياسي بالقوة، في العاشر من يوليو، ١٩٧٨.
4- شكلت أحداث السنوات ١٩٨٩- ١٩٩١ للمرة الثانية مناسبة ممزوجة بالألم و الأمل. فلم تعرف البلاد خطرا، بعد حرب الصحراء الغربية، هدد كيانها ، الدولة و المجتمع، من تلك الأحداث. غير أن عناية الله هيأت أمرين كان لهما دور حاسم في إنقاذ البلاد من الضياع و التلاشي. أما الأمر الأول فتمثل في وجود نظام عربي قومي قوي في العراق، بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين، الذي تدخل لدى النظام السينغالي و لدى الدولة الفرنسية فردعهما عن غزو موريتانيا بفضل تسليحه للجيش الوطني الموريتاني بأسلحة نوعية رادعة ، في تلك الحقبة. أما الأمر الثاني فكان الإعلان المفاجئ من الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد للطايع عن الانفتاح السياسي و التعددية الحزبية و كتابة دستور جديد للبلاد. تداعت حينئذ نخب البلاد، تحت تأثير الصدمة في الاتجاه الإيجابي، إلى الانخراط ،على عجل من أمرها ، في بلورة خياراتها و تحضير نفسها إزاء المعطيات الجديدة و استحقاقاتها التأسيسية و الانتخابية، تاركة وراءها و لو مؤقتا، تجاذباتها الماضية.
5- حملت السنة ٢٠١٩ سمة المنعطف التاريخي بالنظر إلى أمرين: الأمر الأول وصول فئات الشعب الموريتاني كافة إلى إعياء نفسي و هبوط معنوي كبيرين جراء الممارسة اللا أخلاقية و اللاقانونية للسلطة خلال عشر سنوات من نظام عزيز. أما الأمر الثاني فتمثل في حجم الأمل الذي علقه جل الموريتانيين على الرئيس ولد الغزواني؛ و الذي سرعان ما تبخر و تبين الموريتانيون أنهم كانوا يطاردون الوهم و يستمطرون السراب. فخلال هذه السنة خرج الموريتانيون من غيبوبة معنوية دامت عشر سنين مع الرئيس السابق؛ ليدخلوا في غيبوبة معنوية مستمرة أخرى في ظل نظام ولد الغزواني. عاد الجميع، بعد أمل خاطف، للدوران المغثي في الدائرة المفرغة؛ و خاصة ” الأحزاب الكبيرة” التي حملت لواء المعارضة منذ انطلاق التعددية. فقد راحت قيادات هذه الأحزاب تلتمس التغيير بوعظ الرئيس غزواني في القصر الرئاسي و راهنت على الاستثمار في ما يبديه ، في لقاءاته مع قياداتها ، من حسن النية و دماثة الخلق الشخصي. ربما استنكحتها أحلام اليقظة بإمكانية تسيير دفة السلطة من وراء حجاب، كما فعلت ببعضها مع الرئيس المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله. و في كل مرة كان ثمة شياطين بالقصر يوحون لهؤلاء القادة بهذا الإمكان فيغرقون أكثر في الأوهام. و هذه المرة كان الغرق كاملا … و كلما ابتعدوا في عمق الارتهان للأوهام تعدى الفساد مظاهر السلطة و نخبتها الفاسدة بشتى أوجهها و أنشطتها ليطال قواعد و قيادات هذه الأحزاب فحللها في منظومته حتى صارت جزءا مكينا من الفساد العام و نتيجة طبيعية للانحلال القيمي العارم. هذا الانحلال يحصر القيمة في الاعتبارات النفعية و المصالح الشخصية البحتة. لم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية و البلدية الأخيرة إلا صلاة جنازة جماعية على تلك القيادات ” التاريخية للمعارضة التقليدية” و خروجها من المشهد السياسي. و ما الترنحات الأخرى ، ما بعد نتائج الإقتراعات، بعد طول صمت في مجالسات الرئيس غزواني بالقصر الرئاسي، إلا تعبيرا عن التحسر على ضياع المواقف التاريخية و افتقاد المسك بالمصداقية لدى الجماهير. و هنا تكمن خطورة شيخوخة العقل السياسي؛ الذي لم يدرك أن الاستهانة بوعي الشعب هي أكبر عوامل التحطم السياسي. فطيلة الثلاثين سنة الماضية، كانت معظم الأحزاب السياسية القديمة، و المنظمات الحقوقية، ترفع للشعب شعارات براقة و أحيانا شعبوية ذات صلة بآلام الفئات المسحوقة ، بينما تستعين، في السر، قياداتها ، في حملاتهم الانتخابية، بأموال رجال السلطة المستفيدين من الواقع الفاسد. هذا الأمر المفارق انكشف و عرى بانكشافه لعبة السلطة و معارضاتها السياسية و الحقوقية. فقاد العري السياسي النخبة، في ساحة السلطة و ساحة المعارضة، إلى اندثار كثير من عناوينها الحزبية؛ و بعضها في طريق الانتكاس قريبا و التحول إلى مجرد نوادي لأشخاص حازت ذات يوم صفة الرمزية؛ فهي ستكتفي ، في بقية العمر، بمساومة السلطة على سمعتها لدى السفارات الغربية. تلاشت ، إذن، العناوين الحزبية القديمة و سقطت معها رمزية قياداتها، بينما خلف اندثارها فراغا سياسيا و رمزيا في الساحة السياسية الوطنية لم تكن السلطة من الذكاء بحيث تتلافاه قبل حدوثه، كما فعل عزيز و قبله معاوية على نحو محسوب، و ليس في مقدورها الآن ، بعد إقرار نتائج الانتخابات، تدارك هذا الفراغ بعناوين حزبية فارغة ، هيكلا و محتوى، بأوصال حزبية نشأت في ظلمات وزارة الداخلية أو بمبادرة و دفع من إدارة الأمن. كما لن تتمكن من سد أماكن رؤساء تكتل القوى الديموقراطية و التحالف الشعبي و اتحاد قوى التقدم بأشخاص ليس لهم رصيد معنوي و لا مسار سياسي مشهود… كلما لهم من تأثير مزيف هو من فعل تزوير هذه الأجهزة و بالتوجيه إليها. و من هنا تدخل بلادنا المنعطف الأخطر في تاريخها: فلأول مرة تتلاشى ، بمعنى الإفلاس السياسي و المعنوي، النخب المعارضة تقليديا بالتزامن مع وجود سلطة هي الأولى في البلد التي لا تحمل رؤية، في أدنى مستوى، و لا هوية سياسية… و تفتقد هيبة الشعب فيها… و لا تتحكم في التأثير على مجريات أحداثها، هي نفسها. و الأخطر من ذلك كله احتمال استمرار السلطة، أكثر مما حصل، في يد ضعيفة و إرادة مثلومة في بيئة حدودية إقليمية مضطربة و في ظرف دولي ملتهب.
فهل أدركت هذه السلطة أنها دخلت في مأزق سياسي بابتلاعها للمعارضة التقليدية و تغييب خطابها من قبة البرلمان؟ و ما ذا تبقى بيدها من أوجه الاحتمالات للخروج من هذا المأزق؟ و كيف ترسم حدودا فاصلة، إذا فشلت في تدارك مظاهر المعارضة التقليدية، بين خطاب نواب حزب الإنصاف و نواب المعارضة العميلة للسلطة ، لتصنع منها مظاهر خطاب معارض بديل و شبيه بتشنجات نواب المعارضة؟ و ما مقدار فترة تدريب هذه المعارضة على لغة المعارضة و تجويد أدوار التمثيل؟ و ما هي فترة تدريب نواب حزب الإنصاف على هذا الدور التمثيلي من قبل زملائهم في ” الأغلبية- المعارضة” على خشبة مسرح البرلمان؟ و كيف يمنع نواب الإنصاف زملاءهم في” المعارضة المصنّعة” من الوصول إلى مستوى الغرور و التفكير في التمرد على توجيهات وزارة الداخلية و إدارة الأمن ، بعبور الحدود المرسومة لهم في أي ضائقة سياسية يناسب الانتهازيون استغلالها؟ و ما ذا بإمكان تحالف القوى القبلية و متقاعدي الإدارة و قوى الأمن العمومية و كبار رجال الأعمال العسكريين – الذين شكلوا المادة التاريخية للفساد خلال العقود الماضية- أن يفعلوه للجم روح انتهازية رجال “المعارضة العميلة” و محاصرتهم في نطاق جمع المنافع الشخصية( كالتعدي على بعض الأموال العامة، توظيف بعض الأقارب، احتلال بعض المواقع الحكومية …) دون التطلع للمكاسب السياسية التي تنعكس في السعي للسيطرة على عدد من المراكز و الوظائف الحكومية الحساسة و في مؤسسات الدولة الأخرى؛ بما يتيح لقيادات “المعارضة العميلة للسلطة” بعض القوة يمكنهم من ضرب خصومهم في السلطة ببعض نفوذ الحكومة و قوة الدولة… و يدخل الأجنحة الانتهازية داخل السلطة الضعيفة أصلا في احتراب متكافئ، و مكشوف… ؟